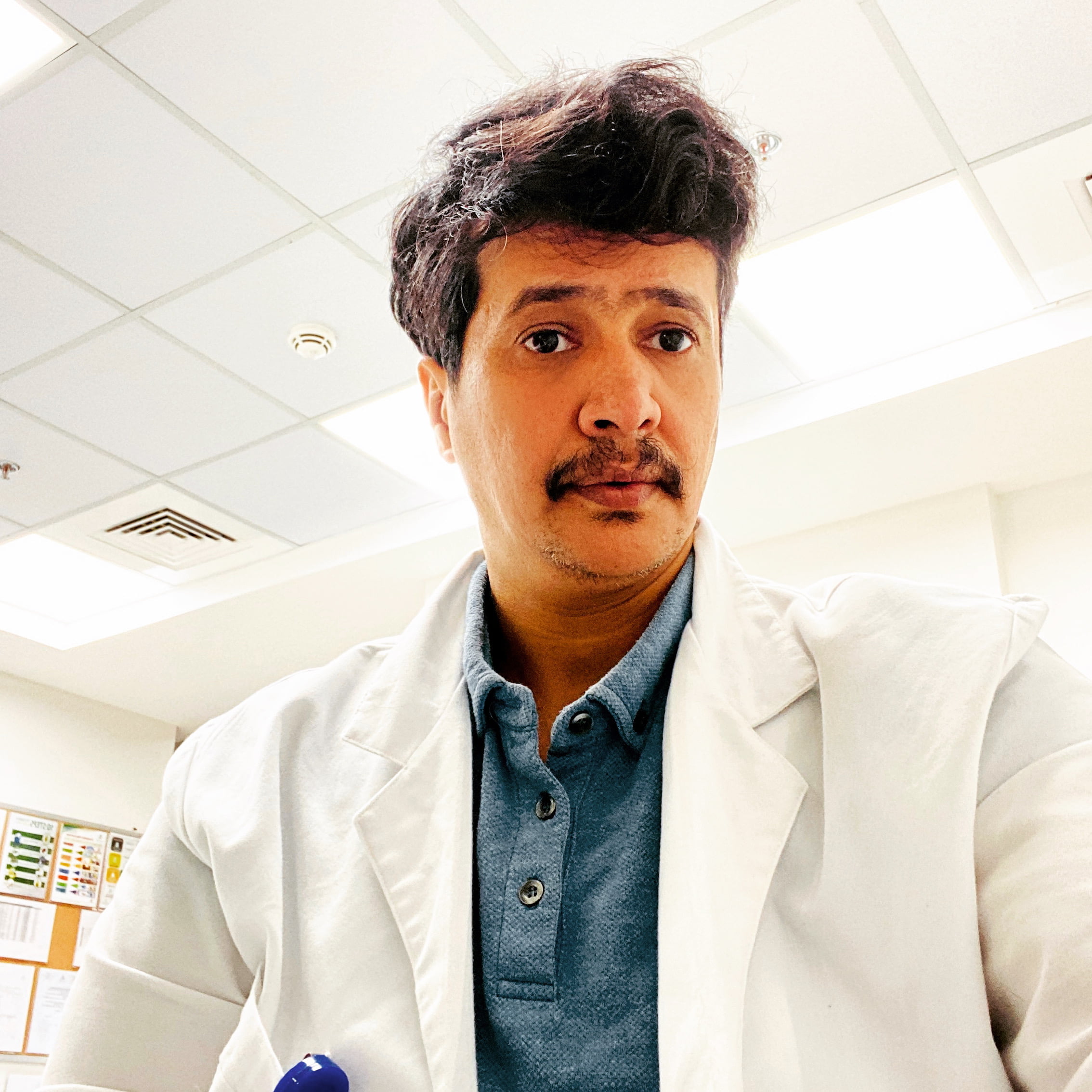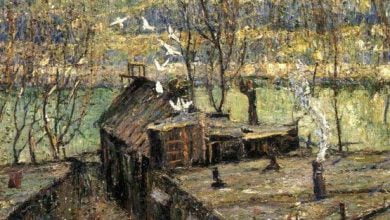العلم ومشكلات الإنسان المعاصر
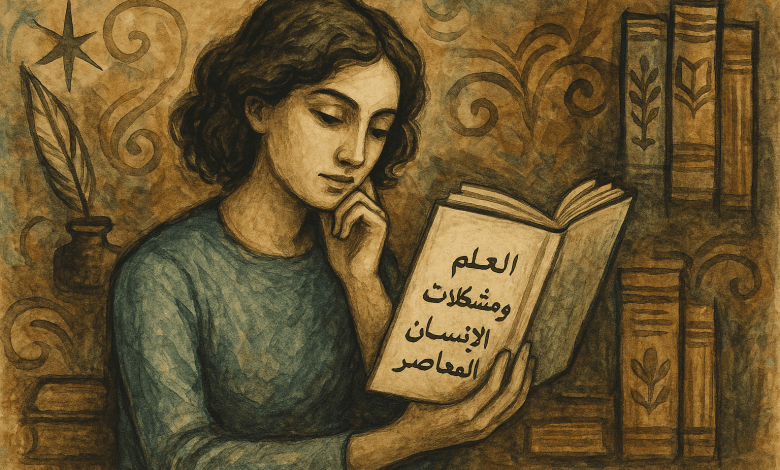
للعالم والمفكر زهير محمود الكرمي (١٩٢١-٢٠٠٩) العديد من المؤلفات والنشاطات العلمية والمعرفية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين بذل فيها جهده لدفع العرب نحو العلم وإحياء المعرفة وكان من بين مؤلفاته كتاب : العلم ومشكلات الإنسان المعاصر، الذي صدر بسلسة المعرفة من الكويت شهر مايو عام ١٩٧٨م.
يقع الكتاب على ٢٤٩ صفحة، مقسّما على مقدمة ثم تسعة فصول تمثل مشكلات متنوعة تطرق لها المؤلف :
الانفجار السكاني والنمو الإنساني، مشكلة الغذاء والعالم، المدينة ومشكلات المدن، التخلف، حماية البيئة، مشكلة الطاقة، مشكلة وقت الفراغ، مشكلة التدخل للسيطرة على الإنسان، مشكلة التغير وانفجار المعلومات.
وقد أحسن في ذلك بنقاشات متنوعة وبلغة مقروءة تخلو من المصطلحات المعقدة التي تحتاج لدراية مسبقة عن معانيها ، ونال بذلك كتابه مكانة في التعريف بمشاكل العلم ببساطة مع تزويد القارئ بجملة من المعلومات الطبية والبيئية.
ناقش زهير الكرمي أيضًا في خضم كتابه معاناة وتطلعات العرب في العصر الحديث لكونهما مرتبطين تماما مع أزمة العلم ونظرتنا إليه. كتب زهير مؤلفه قبل خمسين سنة وها نحن في سنة ٢٠٢٥ نجد الكثير مما كتبه مازال قائمًا وإن كان قد نافسها في التحطيم: الصراعات الطائفية ومأزق الأقليات ورغبتها التاريخية بالسلطة، وأمور أخرى كأمر الاستعمار والسياسة الغربية. بدأ محور اهتمام المؤلف بالعرب بارزا في الفصل الذي يخص مشكلة التخلف، حيث ناقش الحضارة الغربية والفرق بينها وبين الحضارة العلمية، ثم ما يمكننا الاستفادة من التفكير العلمي في علو شأن العرب مستقبلا وهذه القضية بالذات كانت ومازالت أهم ما يشغل المفكرين العرب عادةً،
وفي فصل الانفجار السكاني والنمو الإنساني، ناقش زهير شح الموارد مقابل النمو، وتطرق للهرم والشيخوخة ودور العلم بزيادة متوسط عمر الإنسان ليعود ويتناول المشكلة تحليلية أشد، متناولا مسألة النمو الجسدي والعقلي، وقد وضع حدا للعلم في فهم التعقيد الذي عليه الكائن البشري :
”ذلك أن كل تعليلات علم النفس لا ترقى الى مرتبة الفرضية العلمية لأنها تعلل، في أحسن الحالات، الظاهرة السلوكية التي تبدو على غالبية الافراد . وتظل هناك أقلية، بنسب مختلفة، تتحدى التعليل ولا تتطابق معه. وهذا في العلم مدعاة لسقوط الفرضية وعدم الاخذ بها بشكل مطلق. وقد أدت الأجهزة التكنولوجية الحديثة ومنها العقول الحاسبة الالكترونية وأجهزة قياس التيارات الكهربية العصبية الدماغية خدمات جلى للعلماء الباحثين ومكنتهم من البدء بدراسة الدماغ الانساني علميا … على أنهم مازالوا في بداية الطريق. ومن الأمور التي تزيد الصعوبات في وجه العلماء اختلاف أدمغة بني البشر … ومع أن الفكرة السائدة الى فترة وجيزة كانت أن الدماغ الانساني في جميع الناس واحد من حيث عدد الخلايا العصبية التي تكونه ومن حيث تركيبه وأقسامه – فيما عدا كون دماغ الذكر أكثر وزنا من دماغ الأنثى ببضعة جرامات – الا أن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أنه لا يوجد دماغان يتشابهان تماما. فهناك اختلافات في عدد الخلايا العصبية وفي علاقة الانسجة بالاوعية الدموية التي تغذيها وهناك اختلافات دقيقة حتى في تركيب أقسام الدماغ وأجزائه وعلاقاتها ببعضها“1.
يعيدنا قوله لإشكالية الوعي أمام العلم ثم ما يمكن البحث فيه عن مفهوم الذكاء، وبعيدا عن هذا فقد كانت لغة الكتاب مميزة في مخاطبة القارئ فلم تكن علمية صرفة، حتي بمصطلحاتها، وهو بذلك قد زاد من مقروئية الكتاب وقابليته للفهم عند عامة الناس، وأما فيما يتعلق بمشكلة الانفجار السكاني ذاتها فيرى زهير أن العلم ليس لديه حلول وأن أقصى ما يمكن تقديمه هو حل : تحديد النسل وما قدمه بالعلم فيه لم يتجاوز ”منع الحمل“، مما دفعه لاستشهاد ظريف لقول المعري :
هذا جناه أبي علي ، وما جنيت على أحد“، ولئلا يتجه نحو التشاؤم فقد تطرق المؤلف بعد ذلك نحو تهذيب الفكرة في تحفيز القارئ للقلة الإنجاب لتحسين مستوى المعيشة والتربية.
كانت تلك قراءة عابرة لإحدى المشاكل التي تواجه العلم والإنسان، والكتاب كما ذكرت يشمل مشاكل أخرى قد تطرق لها، وإليك قائمة من الفوائد المعرفية :
- تصميم المدينة العربية ص ١٠٣
- تغيير نمط سلوكيات الطيور التي تعيش بالمدن ص ١٠٧
- مشكلة الوحدة بالمدن، ص١١٢ وقد قدم تحليلا لها :
”أما في المدينة فبالرغم من الاعداد الكبيرة من بني البشر الذين يتصل بهم الفرد، يظل شعوره قويا بأنه وحيد … والوحدة تسبب الكثير من المضاعفات النفسية غير المحمودة. وفي هذا يقول جورج سيمل: («في المدن الكبرى تكون علاقاتنا الحسية قوية ومتصلة بينما تكون علاقاتنا الاجتماعية ضعيفة ومتباعدة»2. - فكرة الباثوثولجيا الحضرية urban pathology. قد استشهد المؤلف بشواهد وأقوال وضرب أمثلة على مدن مختلفة ص ١١٦
- الحضارة الغربية ليست الحضارة العلمية ص ١٢٨
- تطور السلاح ، استشهد بصلاح الدين واستخدامه الخيل العربية مقارنة بخيول الأوروبيين البطيئة ص١٣٧
- تجنب العرب ترجمة شعر اليونانيين وترجموا الفلسفة ص ١٣٨
- نقد زعماء الفكر العربي وغرقهم في بحار الحضارة الغربية جهد الامة العربية بالعصر الحديث توجه توجيها خاطئا – منتقدا عدم تمييزهم بين الحضارة الغربية والحضارة العلمية متهما بانها جهود تلاقت مع جهود الاستعمار ص ١٣٩-١٤٠
- خطأ تطويع الحقيقة الدينية للحقيقة العلمية.
- اركان العلم الثلاث: أسلوب التفكير العلمي ، وطرق البحث العلمي، والتطبيق التقني ص ١٤٤
- السحر عند الغرب وارتفاع أوجه بالقرن الخامس عشر ، وترجمة مارسيليو فيشينو كتب السحر اليونانية والمصرية ، ومعركة العلم مع السحر ص ١٥١
- الآلة والإنسان في العالم الغربي ص ١٥٤ :
“ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن يعتز الانسان بالآلة، باعتبارها امتدادا لذاته ومدعمة لميزاته وقدراته. ولم يكن اعتزاز صانع الآلة بها بأقل من اعتزاز النحات بتمثاله والرسام بلوحته والاديب بنتاجه والموسيقي بمقطوعته .. غير أن الآلة تميزت عن نتاج الاديب والفنان بأن أثرها على الناس بعامة كان أشد وأشمل وأعمق. لا بل امتد أثرها الى حياتهم وبنيتهم الاجتماعية واقتصادهم فغير فيها تغييرات شاملة”3. - حركة اللوديين بالقرن الثامن عشر ص ١٥٥ .
- نقد المناديين للعودة للطبيعة ص ١٦٢
- . تلويث الأرض ص ١٧١
- الزحف الصحراوي ١٧٤
- الفراغ بالمجتمعات المتخلفة
- سرعة التطور العلمي مقارنة ببطء تطور الدراسات الإنسانية ص ٢٤٢
الكتب التي استشهد الكاتب ببعض ما فيها أو ناقشها :
كتاب ”قرن العلم ” لماجنوس بايك ، كتاب ”الإنسان المتغير“ فيليب هاريس , كتاب ”أوروبا بعد نابليون“ دافيد تومسون، كتاب ”اكتشاف المستقبل“ ل ه، ج ويلز، كتاب ”ثقافتان ” واقوال لكل من جوتكلند، ماكس ويز، ألفن توفلر، روبرت اونهايمر ، وآخرون، وقد ذكر المؤلف مجموعة من المراجع للكتاب قيّمة في نهايته وإن كان يعيب الكتاب عدم إحالته للفقرات والأفكار مباشرة في كل فصل.
سنتناول الآن فقرتين أراهما مهمتين من الكتاب، مع تصحيح إحداهن، حيث كانت فقرة المجاعة وتنبؤ وليم كروكس كما كتبه زهير لم تكن نقلا دقيقًا.
عن حركة اللوديين :
يحدثنا د زهير الكرمي بسرد هادئ عن هذه الحركة الاحتجاجية التي ظهرت بين عامي 1811 و1816 في مناطق شمال إنجلترا، مثل نوتنغهام ويوركشير ولانكشير، حيث كان عمّال الصناعات اليدوية (مثل الحائكين وصانعي الأحذية) يحتجون على إدخال آلات جديدة تؤدي إلى خفض الأجور وفقدان الحِرفيين وظائفهم، وقد نُسبت هذه الحركة لشخص أسطوري بالقرن الثامن عشر يُدعى ( Ned Ludd، ومع تسلسل الحديث عن الحركة اتجه المؤلف نحو ذكر بعض المقاومة للصناعات عبر العقود إلى أن يصل للحديث عن أن العلم لن يرجع للنقطة الصفر وأنه لن يعود القهقرى حتى لو حدثت حرب نووية، وقد جازف أكثر ليقول بأن تحكم الآلة بالإنسان خيالا من خيالات الشعراء وتصورا ليس له اساس من الواقع، ولا آعلم إن كان هذا الرأي من الممكن أن يقال اليوم مع تطور الذكاء الصناعي؟ وأما مسألة العودة للطبيعة فيقول زهير :
“أما أن يعود المرء كليةً إلى الحياة حياة بدائية في أحضان الطبيعة فأمر شاعري غير واقعي“ وقد أتفق معه بذلك لكن المعاناة التي يعيشها الإنسان في ظل الحياة الصناعية أكبر من حصرها وجعلها ضئيلة،
وأما عن حركة اللوديين فقد اطلعت على مقالة لريتشارد بارنز في مقالة منشورة بمجلة The Baffler , No. 23 سنة ٢٠١٣ يقول فيها:
“وقد خلَّفَ اللوديون – الذين حطموا مئات من إطارات الحياكة التي تُستخدم في صنع الجوارب، ثم هاجموا لاحقًا مطاحن القص وإطارات القص – موجة دمار شكلت تهديدًا خطيرًا للنظام العام، لدرجة أن آلاف الجنود أُرسلوا لاحتلال مراكز التذمر المناهض للآلات في نوتنغهام وليدز. لقد أصيب أعضاء البرلمان بالذعر الشديد من هذه الحملة المنظمة من العنف ضد الممتلكات، لدرجة أنهم دفعوا بقانون يجعل من اللودية جريمة عقوبتها الإعدام.“4
هذه الحركة كانت أشهر الحركات العالمية في رفض الصناعة والآلة تاريخيا، وفي زمننا الحالي يرى ريتشارد بمقالته ان اللوديين الجدد مسالمون ولا يشكلون تهديدا بالمطلق وخطاباتهم تتسم بعدم المواجهة. واما بخصوص الحركة القديمة فقد واجهتها الحكومة البريطانية بصرامة- كما هو مروي بالتاريخ- بعد مقتل رئيس الوزراء البريطاني سبنسر برسيفال (Spencer Perceval) يوم 11 مايو 1812، حين كان داخلا إلى اللوبي الرئيسي لمجلس العموم في البرلمان البريطاني، أطلق عليه النار بيلينغهام (John Bellingham) من مسدس، فأرداه قتيلًا وبرغم أن القاتل لم يكن له علاقة باللوديين الا ان الظروف الاضطرابية السياسية التي احدثوها جعلت هناك قناعة بانهم هيؤا ظروف الحادثة.
عاد الحديث عن اللوديين مؤخرًا للظهور مع نهضة الذكاء الاصطناعي الذي يظهر أنه سيتخلص حتى من التقنيين، حيث نقترب أكثر من سيطرة التقنية الذاتية إن صح التعبير على الكثير من الأعمال، مما يزيد الهوة بين الأثرياء أصحاب رأس المال وطبقة العمال، وإن كانت اللودية المعاصرة كما وصفها ريتشارد بارنر مسالمة فإننا لا نعلم عن توجهاتها مستقبلا في ظل هذه التغيرات، ثم إنه علينا أيضًا النظر لمسألة رفض الآلة في تراثنا العربي الذي عادة ما كان مرتبطا بالنظرة الدينية كما قيل، لكن هل كان أيضًا يعبر عن مخاوف اقتصادية؟ أو فلنقل نزعة عميقة نحو التمسك بالطبيعة أمام توقعات كبيرة بحياة مضنية لو تمكنت الآلة والصناعة؟.
أزمة الغذاء وخطأ المؤلف..
بمراجعة كتاب زهير الكرمي لم يكن هناك خطأ يستحق التصحيح سوى ما قاله عن نبوءة السير وليام كروس عن مشكلة القمح، فيقول :
ويتوسع كلارك في ايضاح وجهة النظر هذه بتحليل نبوءة السير وليم كروكس التي قالها عام 1896. والسير وليم كروكس كيميائي شهير في تلك الفترة وقد تنبأ بحدوث مجاعة في العالم عام 1930. وقد استند في نبوءته على حساب تضاعف عدد سكان العالم بين عامي 1896 و 1930 حسب ما كانت مؤشرات التزايد الطبيعي والتقديرات الاحصائية تدل عليه. وكان تقديره في تضاعف عدد السكان صحيحا. وكان تقديره الاخر يتعلق بأن انتاج الفدان من الحبوب، في البلاد التي تزرع الحبوب، سينخفض قليلا عام 1930 عنه عام 1896 وفي أفضل الحالات سيبقى على حاله. ومن جمع هذين التقديرين خرج كروكس بنبوءته بأن المجاعة واقعة لا محالة في عام١٩٣٠“ 5
كان خطاب وليم كروكس عام ١٩٩٨ وليس ٩٦ وأما قوله أن المجاعة ستحدث عام ١٩٣٠ فلم يقله كروكس حتى بكتابه : مشكلة القمح، بل قدم كروكس تصورا عن مخاطر ستحدث بعد سنوات من بداية العجز في توفير القمح حيث يقول بصفحة ٢٨ من كتابه مشكلة القمح :
“لكن الاتجاه العام واضح بما فيه الكفاية.حتى لو قامت جميع الدول المنتجة للقمح بتوسيع مساحة زراعتها إلى أقصى طاقتها، ووفقًا لأدق الحسابات، فإن العائد لن يضيف لنا سوى حوالي 100 مليون فدان، وهو ما سيعطي، وفق متوسط الغلة العالمي البالغ 12.7 بوشل لكل فدان، نحو 1,270,000,000 بوشل، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الزيادة السكانية في الدول التي تعتمد على الخبز حتى عام 1931.“ 6
ويستمر زهير في نقل مغلوط عن موضوع مشكلة القمح والكيميائي كروكس فيتحدث عنه :“بنيت على أساس الاسمدة التي كانت معروفة في وقته. ولم يستطع، رغم كونه كيماويا، أن يتنبأ بأن زملاءه علماء الكيمياء سيتمكنون من انتاج أسمدة جديدة بطرق صناعية وكميات كبيرة. وكان أول هؤلاء العلماء“ 7
والحقيقة أن هذا السرد الدرامي غير صحيح وأن كروكس نفسه هو من نادى بالتدخل لمنع المجاعة عبر الكيمياء فيق،ل كروكس بكتابه مشكلة القمح :
”على الرغم من أن الأساليب الزراعية الحديثة قد تكون قد أجّلت الوقت الذي ستُصبح فيه مشكلة القمح في غاية الإلحاح، إلا أن الحقيقة لا تزال قائمة: عاجلًا أو آجلًا، لابد أن ينشأ عجز في القمح، ولن يُعالَج هذا العجز إلا من خلال تصنيع واستخدام الأسمدة الصناعية النيتروجينية على نطاق أوسع.
المجاعة ستُتجنّب من خلال المختبر،
والتطبيق الذكي للنتائج التي يتوصل إليها علماء النبات والكيمياء سيضمن مستقبلًا آمنًا للملايين من آكلي الخبز في العالم.
قبل ثمانية عشر عامًا كتبت:
“نحن ننفق بشغف ملايين لحماية سواحلنا وتجارتنا؛ وملايين أخرى على السفن، والمتفجرات، والمدافع، والرجال؛ ولكننا نُهمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين أنفسنا من أهم ذخيرة في الحروب، وهي: الغذاء.““ 8
كانت تلك النقطة وحيدة في خطأها أمام الكثير من السرد المعرفي الصائب ولم يفتقد الكتاب سوى النقاش المطول عن التفكير العلمي مقارنة بالخرافي، وأما ماعدا ذلك فالكتاب بالمجمل ممتاز ومفيد ويلقي نظرة مبسطة وأولية لأزمة العلم في العالم .
عصام مطير
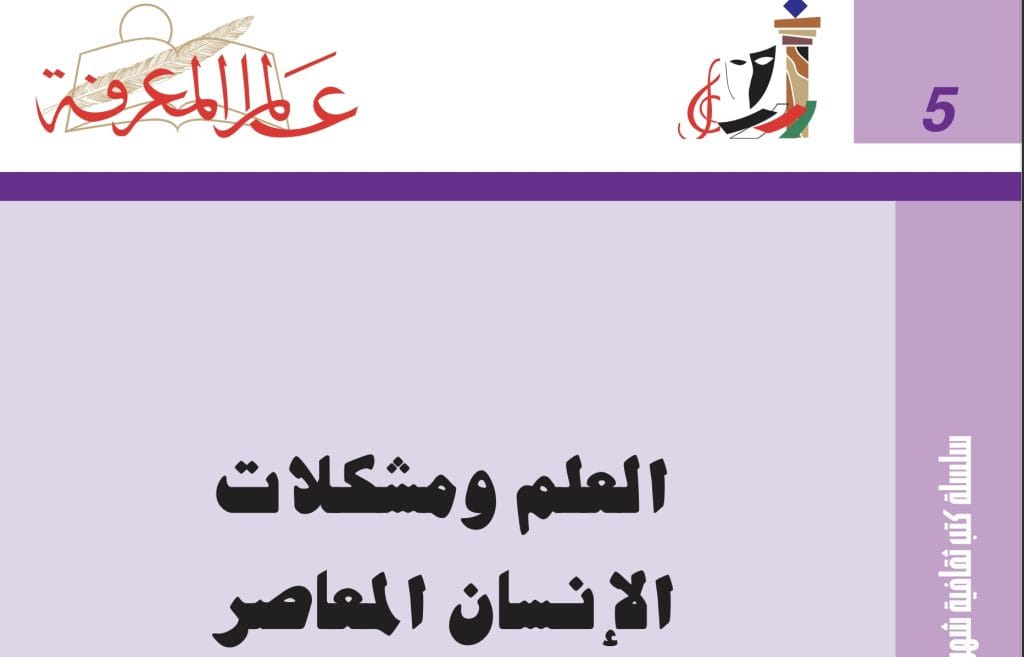
هذه المقالة أيضًا دعوة للحوار في مواضيع الكتاب لمن أراد المشاركة والنقاش عبر التعليقات وبالمساحات والمجموعات بمجتمع ركائز، اقرأ وشاركنا وطور مهاراتك المعرفية