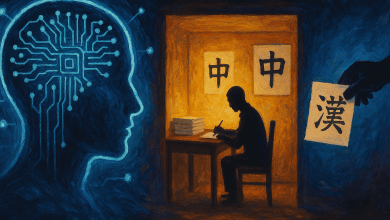الذوق ووحدة الصف !


لتشعر بجمال الشفق الرقيق ، وما تنشده قوافل الغروب ، عليك تنمية “النقاء” في ذاتك ، أن تكون بشعور نظيف ، اتجاه كل شيء يمر من خلالك ، وأن تتجنب السوء ، وترتفع عما يناديك لتنحدر .
فلم أجد أبلغ من النقاء لأشعر بالكون، بجماله ، بروحه الحية ، وحين أفقده ، يذوب العالم كله بالعدم ،
وإنني لأميل لمحبة الغروب إذ تأخذ الشمس طفولةً غريبةً في نهايات وجودها أمام ناظريّ ، وقد لاحظت ذلك في مناطق متباينة لكن أفضل تلك الأماكن كان البحر الأحمر وأنا على شاطئ مدينة الوجه حين غرق قرص الشمس الصغير في رحم البحر ورحابة أمومته ،

وقد يكون ليقظتي التي نال منها النهار مبتغاه وتناولها المساء في قهوته وأخذتها الظلال كأساليب للفنانين بالتقمص والتخفى دورٌ في استعدادي لتقبل الغروب ختامًا جميلًا لكرنفال عالمي الخاص ، على عكس ما إذا لو كان الحديث عن الشروق الذي يطيب لي رؤيته وتشع في نفسي منه الحداثة ونزعة أن أقفز من الصخرة وأحلّق مع النسور لكنه مع ذلك لا يشعرني بشاعرية الاحتياج ، وخشية الرحيل وما تعنيه المغادرة وارتكازي على محاولات القبض على الزمن ، إنه أيضًا يناسبني جدًا أن يمتزج الاحمرار بخفوت الشعور لا بنشاطه ، ولكن
هل هذا ما يجب أن يكون عليه الجميع ؟ أو هل كان ذلك هو الاختيار التفضيلي الطبيعي عند أي إنسان محب للطبيعة ومقترب جدًا من الموسيقى؟
إنه الذوق فقط فلربما كان الشروق أجمل وأفضل من الغروب عند من نهضت قواه ووجد حاجته بالمستقبل أشد جاذبية من رغبته بالبكاء وميله للاستماع لجداته وقصصهن آخر الليل ، ومع كونه ذوقًا جماليًا نابعا من الحاجة والشعور البصري وارتباطات الذاكرة ونزعات الهدوء والانطلاق إلا أنه أيضًا له حدود في مساحات الاختلاف وما أن يكون العزوف عن بعض الخيارات المتعلقة بجودة الحياة ، تنشط كلمة الذوق الرديء وهكذا
إنني أميز بين الذوق الجيد والرديء بعناصر كثيرة لكن هناك مساحة تسَعُ درجات مختلفة من الجودة مادامها تعني الجمال والطبيعة ، أي السعي نحو الإثارة المدهشة للذات التي تراعي الطبيعة في تكوينها ، وهذا ببساطة أمر مختلف عليه بين الأذواق لكن ثمة أمور مشتركة للذين تقدموا بخبرات الحياة ، فمثلا تمنحنا آلة الكمان “موسيقى” لا يمكن أن نفضل عليها موسيقى مشابهة لها بالإيقاع والتكوين يصنعها الكمبيوتر ، وحتى تلك الفلاتر الصوتية وحفلات الأورج لن تمنحنا الشعور الرائع الذي تقوم به الات الموسيقى التقليدية وهكذا.
وقد يقع على الذوق الأثر الثقافي ، الفئة العمرية ، والعاطفة التي حين تكون حبًا نبصر جمالًا إضافيًا وحين الكراهية تدفعنا لإبصار القبح والعيوب وهذا فحوى ما قاله الشافعي :
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ
ولكن عين السخط تبدي المساويا
وقد يكون الذوق بمزيجه العاطفي خاص جدًا بالشعور المتأجج وله علاقة بالتفاهم والانسجام فهذه بثينة التي كتب بها جميل القصائد وخلدها شعرًا قد دخلت على عبدالملك بن مروان فراها امرأة مولّية فقال ما الذي رأى فيك جميل ؟ ، فقالت : الذي رأى فيك الناس حين خلفوك ، مما دفع عبدالملك بن مروان للضحك .
“ما الذي رآه فيك جميل ؟“
العبارة تنم عن نظرة غبية للحياة بكونها شعورا موحّدا ، يتقاسم الناس فيه معاني الجمال بقيم مشتركة لا نسبية بها ، وهذه بذرة توحيد الأذواق التي تسببت بفساد الإبداع أو قلته في ظل كثافة الاتجاه الذي يريد أن يكون الذوق ولاءً يشابه الولاء الديني والوطني في الدول التي تتجه بشعوبها للتشابه الصارم خشية التفكك وهي فوبيا خاصة بالمجانين الفراعنة الذين يقتدون بفرعون “لا أريكم إلا ما أرى”.
لقد رأى جميل ببثينة ما لا يبصره غيره ، فالشعور بالآخر ليس مسألة شكلية فقط ، بل يتداخل معه أو به إدراك الهوية والموقف والذاكرة ، ونحن بقدر ما نتقبل الشخصي وننمي التنوع ونسمح بانطلاق جماعات الأذواق في ساحات الأدب والفنون بتنافس حر فإننا نمنح فرصا كبرى لنمو الإبداع فالقمع الذي تفرضه العقليات السلفية التقليدية على الأذواق قد يتسبب بخسارة المعنى ككل وحتى الذين يفضلون الطبيعة بصفتها مصدرا للجمال على الصناعي بصفته محاكاة رديئة وأنا منهم ينبغي أن ننافس لا أن نقمع ونمنح الآخر شرف الانزواء والمقاومة.
لقد اتضح لي بأن الجمال في سياقات عاطفية ، له معنى وشعور خاص ، كمعنى وشعور (أنا )
ولا يستطيع المرء منا أن يدرك ذاتًا غير ذاته ، تكونه ويكونها ، لكنه يجد شيئًا مقاربًا لذلك ، يأتي به الحب ، ويصب به معناه ليقيم الشعور الخاص بالجمال الذي بدوره يعني رغبتنا بالحياة ، الحياة بمعنى النعيم.
ما الذي يجعل الورود والأزهار بهذا الذوق الفني الرفيع المتمثل بتلك الألوان المثيرة الزهيّة؟
إنها الحكمة الإلهية التي تريد منا النظر نحو المستقبل بحب ورغبة وأمل ، وقد نشأ الذوق اعتمادًا على نزعة السعي للمستقبل مع الحفاظ على آفضل لحظات العمر المكتظة بالأمان والملذات الحسية التي أرى أنها كلما كانت مرتبطة بالطبيعة كانت أعمق في تكوين التوهج الحيوي للشعور بالجمال والسعي لبقائه من خلال هذه المعايير التي نسميها ذوقًا ، وهي بالتالي امتداد للهوية والانتماء وما يجري على الذوق من تطور وتحسن له علاقة بتوسع معنى الهوية والانتماء عند الشخص ، لكن التوسع المقصود ليس الكثرة بل التحرر من كل تلك الانتماءات الصغيرة التي تقيد المرء والانطلاق لفضاء أوسع لمعنى الانتماء ، وهو ما يحدث عادة بالتدرج ، وقد لا يصل المرء لمنتهاه ويبقى بدائرة متوسطة لكنه من حيث المقارنة أفضل من غيره ممن لم يبذلوا جهدا أو حتى استمتاعا وزمنا في اكتشاف ما لدى الآخرين ، فهذا الشاعر بصفته مثالا للانتباه واليقظة الفنية والشعور بجمال المحيط والأشياء سيفضل التعمق اللغوي والتجوّل بين الأساليب وسيغادر مجتمعه بقدر ما يزداد عنده الشعور الجمالي وهي مسألة تفاعلية أيضًا فالتعمق والتجول والمغادرة تقوم جميعها على زيادة الشعور الجمالي كذلك.
لننظر للنصوص الجميلة بالشعر العربي ، لقد حملت بصمة مغادرة المجتمع المحلي ، وإذا تعقبنا شاعرها لوجدناه في معظم الأمثلة رحّالا ، ولم يستقر في قريته مدى عمره ، وقد اختلط بثقافات مختلفة ، إما بالرحيل أو بالتجوال بين القبائل المختلفة أو باختلاطه بهم ، وللمكان حينها دور تفاعلي بالكشف عن الممكن إثارته لدى الشاعر وما يجدر به أن يكون إلهامًا وبهذا فإن النصوص لديه من تقدم معنى الهوية والانتماء ،
ومما ينبغي ذكره والتذكير به أن الذوق الجيد أيضًا ثروة قابلة للضياع أو التشظي وليست تراكمية للأفضل بلا تقهقر أو تحطم فحين يُعرض الذوق بأوساط لم تبذل جهدا في تطوير ذائقتها شعورها بالجمال من خلال القراءة والتأمل، وتجربة المعاني لابد أن يدخل صاحبه بتزامنية تجعله رويدًا رويدًا يتنازل عن بعض المذاقات المميزة ليتواصل مع من حوله.
إن إحدى الإشكاليات التي يواجهها النص بمجتمعاتنا العربية ، مواجهة الذوق المحلي الذي عادة ما يكون تقليديا ويتسم بالضعف والرداءة أيضًا مع حالة التردي للغة والثقافة وهنا يعمل المجتمع على تقييد النص بمستواه الفكري والجمالي ، فيؤثر سلبا على اختيار الأفكار ، الخيالات ، أساليب البلاغة ، فالشاعر بالنهاية لا يكلم نفسه ، بل ينتقل بطور البناء لمخاطبة مجتمعه الخاص فمجتمعه العام ثم يدع النص يأخذ حيزه بتاريخ الأدب ، وللأسف فإن المسألة الاجتماعية المحلية ليست متوقفة على ذلك فهناك نزعة توحيد الذوق التي تأتي على أشكال ضمنية مختلفة ، منها ما يكون في عداد الجوائز التي هي تعبير عن المحلي المدعوم حكوميًا ومنها ما يأتي على شكل أندية أدبية ورقابات مما يدفع للشللية ومع هيمنة نزعة توحيد المذاهب الفقهية بفترات مضت نشأت نزعة توحيد الذوق الشعري فأصبحت السلفية اللغوية تحد بطريقة ما التقدم الإبداعي مع تسلط الإقليمية والقبلية ضمنيًا أو حتى علنيًا كما يحدث بمسابقات الأدب التي تعتمد على التصويت وإثارة المسألة القبلية أو الإقليمية لزيادة دخل القائمين على البرنامج ونجاحه وإذا نظرنا لتكوين المجتمع العربي أيضًا ، من حيث أنه مجتمع تمكن من تحويل الخوف لعادات وتقاليد بالتدخل بشؤون الآخرين والتسلط عليهم للمحافظة على وحدة الذوق التي تندرج بشكل أو بآخر على فكرة وحدة الصف
فإن عبقرية النص ، النبوغ المدهش للموهبة الأدبية ، ستكون مدعاة للنيل منها ومواجهتها.
إن الذوق الأدبي مسألة اجتماعية بكثير من أجزائه ، والمجتمع الذي يعمل على محاربة مبدعيه لأسباب عنصرية أو حزبية ، لن يدخر جهدا بتصنيع مستويات ذوقية للأدب تتناسب معه ومع أن الأدب هو نشاط النخبة ، فإنه كالدين الذي تشارك به العامة وتحدد شكله المقبول ، إنني أتكلم هنا عن الشكل والأسلوب للنص ، انطلاقا من الذوق وهكذا فالأديب إذا لم يكن بنزعة قيادية (أو نرجسية) تدفعه للتعالي سيسقط بقيود ورغبات محيطه الخاص وما به من ذوق لا يصلح أبدًا لبناء نص جديد ، جديد بمعناه الإبداعي وهذا قد يفسر لنا لماذا كان أهم المبدعين شعرًا عند العرب هم أولئك النرجسيين !!
ينبغي إذن على الأديب الانتباه جيدا لحيوية وتكوينات الذوق الذي يحمله كي لا يخسره بمحيط سيء وللجاحظ مقولة :
“لا تجالس الحمقى فإنه يعلق بك من مجالستهم يوماً من الفساد ما يعلق بك من مجالسة العقلاء دهراً من الصلاح فإن الفساد أشد التحاماً بالطبائع “.
الجاحظ
،
أرى رأيه أبلغ في معناه العام حين نتكلم به عن الذوق ، لأن المرء سرعان ما يفقد ذوقه الجمالي مقارنة بفقدان عقله وطرق تفكيره وعلى نفس المسار نستنبط المعنى ذاته من بيت المعري :
ولا تجلس إلى أهل الدنايا
فإن خلائق السفهاء تُعدي
،
المعري
ومن الأمور ذات العلاقة ، وجدنا الإلهام والذوق يشكلان معًا دافعية للجمال بالنص واستمراريته ، فاستمرارية النص ليست مسألة إلهام وحيوية فقط بل يدخل معهم الذوق أيضًا لأنه يعمل على تحقيق ذاته في النصوص وإشعار صاحبه بالندم أو الانزعاج إن لم يرتفع به ، وقد يكون القليل من الإلهام كافيًا لاشتعال النص بوجود ذوق رفيع وهذا بالطبع يعدل فكرتنا عن صدق العاطفة ، مصطلح النقاد البسيط ، فالأمر أكبر من مسألة صدق أو كذب حين نتحدث عن الجودة بالنص وإثارته الجميلة ، وعلينا النظر أيضًا لتموجات النص الجمالية بين هبوط وارتفاع وقراءتها بكونها ذوق مضطرب حين النظم وليس فقط انخفاض بالمؤثر الملهم ، وبالنسبة للحيوية فهي أساس مهم بالذوق ولا يمكن استثناء الجسدي من هذه المسألة وكذلك ما يقوم عليها من انطلاقية تعتمد أيضًا على نزعة القيادة أو التحرر ، فالانطلاقية مزيج بين ما هو جسدي وما هو اجتماعي وهي مهمة جدًا في تطور الذوق ، إنها حيوية الاستغراق بما تحب فعله دون كلل أو ملل وشريطتها التحزز النفسي من تسلط الآخرين ولهذا كانت بيئة الإبداع حظًا ورزقًا من الله لبعض البشر ،
فمن ذا يستطيع هزيمة القالب المحكوم بقوـي التسيد والتحاسد وحركته القهرية في توحيد الذوق والشكل؟
ربما بالانطواء والطبيعة
عصام مطير
الرسمة الملحقة للرسامة البريطانية Rachel Toll