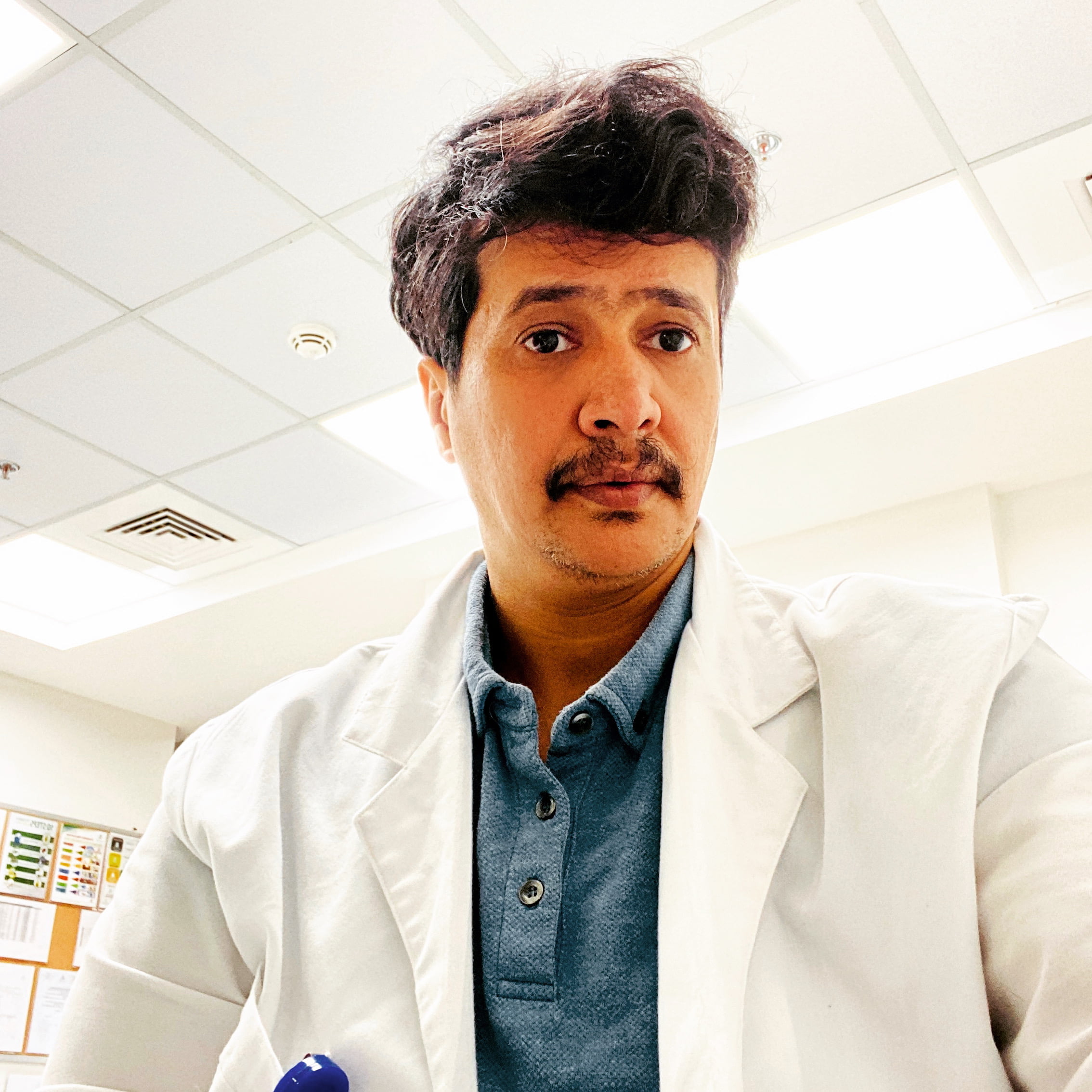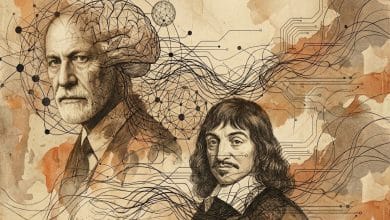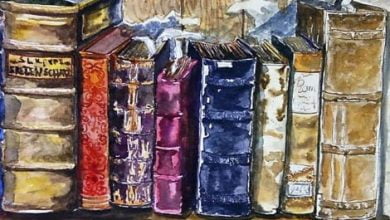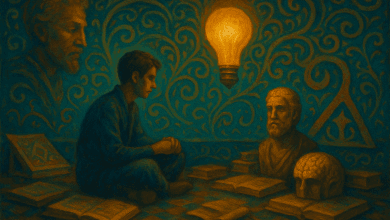راشد الماجد وشوبنهاور والطرب
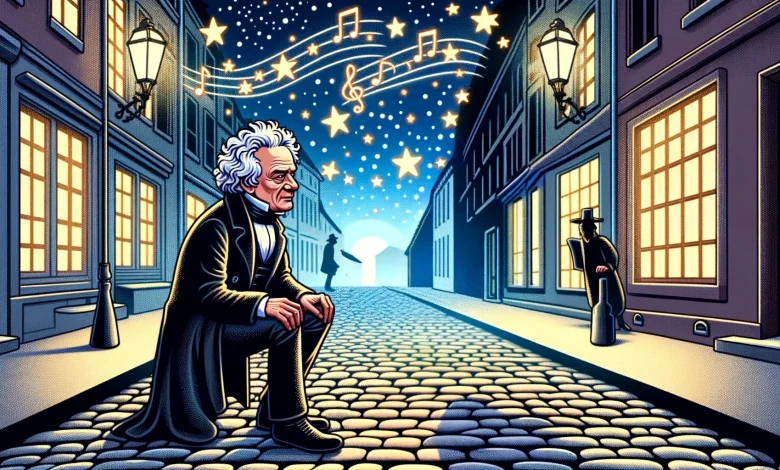
لدي علاقةٌ طيبةٌ مع راشد الماجد، أعني فنَّهُ، على الرغم من كوني لم أحمل يومًا رغبة بشراء أي شريطٍ له في زمنٍ مضى، وما أبداه لمسمعيَّ لم يكن سوى لحظاتٍ عابرة، ودقائق تأتي مصادفة، ثم أجواء يختارها غيري للمكان، وعلى مر السنوات كان هذا وجوده في زمني الخاص، ومع ذلك أيضا لا أذكر أنني تجاهلت ما يغنيه حينها أو انزعجت من صوته أو حتى فضلت أغنية لأسمعها بديلة لغنائه، وهأنذا أستمع له مصادفة في ركن مقهى، وقد تقاطرت الذكريات التي كانت، وانبثقت أسئلتي عني وعن الوجود بمعانيه الشائكة،
ما هذا الجمال الذي حافظتُ عليه بلا غرامٍ عظيم له ولا حرص شديد عليه؟ لقد انطفأ عبدالحليم وفقد كاظم بريقه أما ماجدة الرومي التي كان لها ما لها في ذهني الفني، ها هي جزءٌ من الماضي، أعود له أحيانًا على سبيل المراجعات النفسية، وبقت لذة أغاني راشد الماجد كما هي، أهذا ما يفعله البطء والتغاضي الطفيف ببقاء رونق الحياة أم هذا فعل الغرام بالآخرين إذ ينال كل معنى ثم يفرّغ الجمال من محتواه؟.
تدهور الطرب ، والشاشة والطبيعة..
إنه قلّما نجد بالأغاني الجديدة مقارنةً فيما مضى من عقود، ما يمنحنا هذا التوهج الطربي، وذلك التهيام القديم، الذي كنا نعيشه، وبنظرة لمكتبة العرب الغنائية سنجد أن الغناء بفنانيه القدامى مازال متميزًا في اللحن والكلمة مما يدفعني للتفكير إذا ما كان هذا التفضيل ناجمًا من مسألة ذاتية تخصني وحدي وقد يشاركني جيلي ذلك التفضيل لأسباب مشتركة أيضًا إذ أن ذوقي امتدادٌ لعصر الطبيعة (ذكريات الوادي والشاطئ) قبل أن تعلن الشاشة عن نفسها بالطريقة التي نشاهدها اليوم، وهو بذلك يلحظ ما لا يلحظه غيره، باستثناء أبناء جيلي ، إذ أننا نشأنا جميعًا حينئذ محاطين بجودة فنية ممتدة من أثر الطبيعة ذاتها.
تحدث “أكتافيو باث” عن الشعر ونهاية القرن1 وقد أبدى معرفة عميقة بالشعر وكيف لا يعرف وهو الشاعر بالإضافة لكونه فيلسوفا وسياسيا ، وهذا التنوع في نفسه يُريه ما لا يُري غيره ، وقد أبرز بكتابه التدهور الشعري بهذا العصر، ولم يعن به نهاية الشعر بل تغيره الوظيفي والاجتماعي وحين نتأمل الشعر اليوم في قرننا هذا قد يظهر أننا في مراحل تسارعية بتهميش أثره في ظل تضخم الآلة، والشاشة والألعاب، وتحول الإنسان المعاصر لفرد آلي، يعتمد على التواصل عبر وسيط (الشاشة) وقد ابتعد كثيرا عن الطبيعة، مما يدفع نحو ضعف التأثير، للكلمة الشعرية، إلى أن تعود الطبيعة لما كانت، وهذا بالضبط ما يجعلني أعتقد بأن التحولات التي عشتها منذ أن جاء عصر ”الشبكات/الانترنت“ وتطور الجوالات الذكية، تشير جميعها إلى أن الطبيعة التي ابتعدت قليلا قد أخذت معها الطربية في الغناء والذات معًا لكن علينا جميعًا أن ندرك أن الشعر لا يموت وهو جزء من الوجود البشري وقد تختلف مظاهره ويقل عمقه ويتجه للقصصي والروائي بصفتهما (حصنا منيعا له) إلى أن تعود الطبيعة لما كانت عليه.
تدهور الطرب، الأسباب الأخرى …
إن الطربية تعتمد على حيوية الجسد وما يكون من قالب معتاد في ظهورها، وهي بالمدينة الحالية في ظل الزحام والتلوث تعيدنا لمشكلة القاهرة مع تدهور الطربي بها رويدا رويدا في ظل تغيراتها وامتداداتها هي بالسكان والزحام والرأس-مال، فالفن العربي في مصر بالخمسينات إلى الثمانينات كان يحمل اهتماما كبيرا بالكلمة واللحن، وهو امتداد لمكانة الليل حينها، والطبيعة، مقارنة بزمن الشاشات كما أسلفت، ثم إن قرب تلك العقود للشعر الممتد من تجربة الإنسان الطبيعي الذي يعيش حينها في بدايات الحضارة قد دفعت لجودة الكلمة، وعمقها بل الانتباه لمعناها، وحتى في نطاق الاستعارة الشعرية، كانت النصوص الغنائية مليئة بالتصاوير والتشابيه، وما أن امتدت الرأسمالية لذروتها، وزاد وجود الشاشة، والتقنية حتى انخفض الانتباه وبتزامن معه انخفضت الاستعارة وجودة النص، وأصبح الكلام المباشر السريع يمثل رتم العصر، وقد زامن ذلك أيضًا تدهور الأجساد وهو مبحث يطول تفسيره..
المدينة وأثرها..
لم يتوقف أثر التحولات بالمدينة على إبعاد الطبيعة بل حتي بمفهوم الحرية والوعي به.
ثمة علاقة ضمنية بين الحرية والجودة، والحرية هنا بمعناها الأوسع، حيث يضيق المرء بالقوانين والإشارات والعواقب وهي بدورها تزيد من التحطم فالفن منتج الحرية بالنهاية، والمدنية اليوم تدفع نحو الكآبة والإرهاق حتى على مستوى الاستماع، فبذلك يكون للصخب السريع أهميته على الصخب القابل للتأمل.
لم تقتصر المدينة علي تلك التحولات فهناك شراهة وإفراط باستخدام الحواس لدى الفرد بها، فالاستماع اليوم ليس كما كان سابقا حيث بالكاد تسمع بعض الجيران والزملاء وأما اليوم فيغلب الصوت كل ثانية ومكان، بالسيارة، بالرصيف، بالقاعة إلخ وهو يصب بانخفاض المتعة والاتجاه للصخب العالي والمعنى المفقود.
ثم بعد هذا فعلت المدينة فعلتها الكبرى في تقنين أو تحديد معالم وظيفية للفن يأتي هذا عبر انتصار الأكاديمية على الفنان (الملحن ، الشاعر) وهي ظاهرة تشبه موت المثقف في ظل كل جامعة لها فروع وآلاف الدكاترة بالجزئيات واهتمام الناس بالسلطوي والشكلي ومحاربة الإبداعي لكونه لم يأتي من ”السبّورة“!.
شوبنهاور وتدهور الطرب..
إن ارتفاع ظاهرة الموسيقى المستقلة (المجردة) (موسيقى بيتهوفن مثلا وغيرها إلى اليوم) ، بعالمنا العربي كان يقف خلفه العولمة وأيضًا تأثير الشاشة لحاجة البرامج لصوتيات موسيقية دون غناء، وهو بدوره ساعد على تقبّل وجود الموسيقى المستقلة وتذوقها، هذه الظاهرة وإن كان لها حقها بالوجود فقد ساعدت بتدهور الطرب الغنائي من جهة أخرى.
يجادل شوبنهاور بأن الموسيقى، على عكس أشكال الفن الأخرى مثل الشعر والرسم، لا تمثل العالم الظاهري أو مظاهر الإرادة الفردية. بل يعتقد أن الموسيقى تجسد الإرادة العالمية نفسها – القوة الكامنة وراء كل الوجود. من وجهة نظره، تعكس الموسيقى الإرادة مباشرة وتعبر عن جوهر واقع العالم، متجاوزةً الفرد وتفاصيل الزمان والمكان.
بالنسبة لشوبنهاور، كانت الموسيقى تمتلك عالمية لا يمكن لأي شكل فني آخر مطابقتها. رآها كشكل نقي من الفن غير ملوث بالعالم المادي، مقدمةً رؤية مباشرة لطبيعة الإرادة دون وساطة التمثيل المادي أو التجريد المفاهيمي. هذا يجعل الموسيقى لغة عالمية يمكن لأي شخص فهمها بغض النظر عن خلفيته الثقافية أو الاجتماعية.
شوبنهاور دفع الموسيقى لأبعاد ميتافيزيقة (فلسفية) لكن على مستوى اجتماعي إن ابتعادها عن الشعر دفع بالأغنية للتدهور من خلال الاهتمام أكثر مما يجب بالموسيقى، وقد انتقل هذا للعرب ببطء واليوم نجد الكثير من المقطوعات الموسيقية المجردة لها جمهورها لكن ثمة علاقة بين ارتفاع هذا الفن المجرد وانخفاض قيمة الطرب الغنائي واندفاع الذوق للموسيقى السريعة الصاخبة والكلمات التي لا تحمل الحد الأدنى من الخيال المثير والموقف والقصة.
“الموسيقى لو اتحدت بالكلمات أكثر مما ينبغي، لكانت بذلك تحاول أن تتكلم بلغة غير لغتها”
شوبنهاور2
المزيد عن الموسيقى..
كانت الموسيقى بعز وجودها عبر التاريخ جزءًا من الغناء الشعري غالبًا، ولعل جذور الفكرة : بأن الإلهام يأتي من الإله إلى الشعراء، جاء من أثر الموسيقى ذاتها وهيمنة الفيثاغورية
“إن الموسيقى البشرية الفانية ما هي إلا أنموذج أرضي للانسجام العلوي للأفلاك “* فيثاغورس3
زعم الفيثاغوريون بأن “انسجام الأفلاك يعتمد على افتراض أن الحركة تقترن بالصوت ضرورةً، وأن الصوت المنبعث من النجوم المتحركة ينبغي أن يكون متناسبا مع حجمها وسرعتها،وأن المسافات بين الكواكب وأفلاك النجوم تطابق رياضيا المسافات بين الأصوات الثمانية في السلم الموسيقي ” وقد قدّم الفيثاغوريون تحليلا لعدم سماعنا هذه الموسيقى:”ليس لنا أن نتوقع إدراك صوت كان منبعثًا وقت ولادتنا وظل قائمًا بلا انقطاع حتى الآن، ذلك لأن الصوت لا يدرك إلا بالتقابل مع فترات السكون” وقد اعترض أرسطو على هذه النظرية وفندها4 وليس لدي دراية ما هو موقف الفيزياء اليوم من هذه الفرضيات الفلسفية، لكن ما يهمني هو الاعتقاد اليوناني القديم بعلوية الموسيقى، مما يدفعنا للنظر إلى الشعر بكونه يحمل جزءًا آخرًا من الغموض الدافع نحو السماء، ليس التخييل بل الموسيقى.
الموسيقى والشعر ..
تربط الموسيقى بين المادي الذي يشير للعقلي متمثلا بـ (الكلمات) والنفسي الذي يشير للروحي (المعنى مشوبًا بعاطفة وذاكرة ما ، مشيرًا نحو حيوية وعي).
إن الموسيقى بعلاقة متينة غامضة مع الذات التي تمر من خلالها كل الأشياء وتبقى ، ويحاول الزمان بها فتظل واقفةً ، (تطوف على إيقاع عميق).
يعتمد الشعر على انزياحين رئيسيين : “انزياح بمستوى دلالي (الاستعارة) وانزياح بمستوى صوتي (الموسيقى)5 ،” وقد كان الشعر الغنائي (الذي عليه شعر العرب عموديًا وتفعيلةً) هو اكتمال الحالة الانزياحية في حين كان النثر الفني (قصيدة النثر) مهتمة بالجانب الدلالي فقط ، مما دفع لقلة رواجها ، فليس من السهل قبول الكلمات بلا موسيقى لأن الموسيقى (روح) أو شبه روح ولربما اعتقد المرء بلا وعي منه في كونها ”سماوية”.
”“هل تستطيع أن تتذكر أي قصائد تحفظ منها على الأقل بضعة أسطر؟ ولماذا تتذكر تلك الأسطر دون غيرها؟ وماذا عن أناشيد الطفولة؟ هل يمكنك أن تتذكر أيًّا منها؟ عندما تكون في السيارة تستمع إلى الراديو، كم أغنية تستطيع أن تغنيها مع المغنّي؟ على الأرجح كثير منها.
هل تساءلت يومًا
لماذا نملك القدرة على تذكّر آلاف كلمات الأغاني ولكننا لا نستطيع تذكّر ما تناولناه في الإفطار؟
نحن نتذكّر كلمات الأغاني والشعر لأن أدمغتنا مبرمجة لتستجيب للإيقاعات والتناغم. إن الهبة المتمثلة في أن يُتذكّر الشيء هي ما تمنحه العناصر الموسيقية للقصيدة.“
Nikki Moustaki,6
مدهشٌ ما تفعله بي الموسيقى 🎶
تساعدني الموسيقى على نظم الحياة، والأخذ بعواصفي الذهنية نحو مآلات لا تنتهي، وأنا حيث كل ذلك أعي وأبصر وأتخلص.. إن ميولي للشعر منذ البداية، هو تعبير عن وجودي الموسيقي أي حقيقتي في كوني إيقاعًا خاصًا للحياة قرر أن يتجسد ثم بدا له أن يعود لجذوره.
يقال أن الشعر حاد عن الباطن النفسي وأن الموسيقى هي الأعمق، ربما كان هذا التصور له ما يؤيده في كون الشعور البدائي يظهر كانفعالات سرعان ما تُربط بالمعاني المؤثرة، أن تكون بشعور متدفق ومزاج عالي مثلا فتربطهما بالجو وبمن قابلت وبماذا سمعت، وأن الشعر للخارج منذ بدايته لكنني حين أتأمل المسألة ينبغي أن أعترف بأن بعض الانفعالات جسدية خالصة، وينطبق عليها مسألة الربط الذهني لكن هذه الانفعالات أو العواطف الخالصة، قليلة ومعظم البقية منمط ليكون موجّها للمعنى، فالعمق الإنساني هو معاني متناقضة متضاربة وذكريات تقاوم العدم وأخرى شجاعة مهيمنة على وعينا.
الموسيقى المجردة مرةً أخرى..
لم يعهد العرب في تاريخهم حالهم حال البقية أن تكون الموسيقي مسموعة لذاتها، وإن كانت بعض الأمم قد بدأت هذا الاتجاه مبكرا عنا، فإن سلطة الشعر الاجتماعية بأمتنا تجعلنا نستثمر اللحن الموسيقي في الغناء، فالموسيقى الخالصة، مجردة من معاني الفهم، وتلذذنا بها تلذذ حسي وإثارات نفسية بلا تفسير فكري، وهذا النوع المجرد له قلة يصغون إليه حتى اليوم ، ويحتاجون لتطور فني مناسب للاستماع لموسيقى تعمل كخلفية أو كوسيلة للتأمل أو كتهدئة تشبه النوم ولا نوم،
وأما معظم الموسيقى التي نسمعها فهي للغناء، للشعر وإنشاده وتقديمه بمجهر الطرب، ومع ذلك نجد من الموسيقى ما يتجاوز هذا التقييم، وما يثير بنا وعيًا جماليا بالحياة وإن كان نادرًا بالطبع.
النداء بين الموسيقى والشعر
إن الكامن في الموسيقى، اعتقادنا الضمني بأن الإبداع يعني حياة جديدة واتساعًا ورحابة، ولأن الموسيقى لابد أن تكون إبداعًا فهي تشدنا بلا وعي منا لهذا المعنى، وقد جاء الشعر في سياق النجاة، لأنه التعبير الذي اعتمد في وجوده على الموسيقى ليتحرر من الضيق (الكلام المعتاد) على أن الموسيقى تحمل ما لا يحمله الشعر من نداء، فإذا كنا نجد بالشعر اتجاها لأفكار نعيها ومعاني نرتشفها وإنسانًا يحيي ذاكرتنا فيما يقوله فإننا بالموسيقى لا نجد سوى النداء فقط وهي اللحظة التي نعي بها أن هناك من يقول “يا”، لكنه لا يكمل جملته، وهنا مربط الفرس، فهذه الموسيقى تكبّر لحظة النداء وتدعنا نعيشها على غير ما يفعل الشعر الذي يكبّر لحظة الحدث وإذا قلنا أن الشعر لغة للغة فالموسيقى تتجاوز ذلك بكونها جمال السمو عليها، حيث هناك شيء يشبه أن يكون لغة لكنه يتجاوزها.
على ضفة أخرى أقول أن الموسيقى نداء، لم يكتمل، وحين نستمع لأغنية ما، تقوم الموسيقى بهذا الدور الندائي ليكون الشعر هو كمال هذه الوظيفة، فالغناء بشقه الموسيقي ينادي، وبشقه الشعري يدفعنا للإصغاء بناءً على أن “يا” الموسيقية الموجهة نحونا قد أكملت جملتها بالنص الشعري.
المطرب هنا هو الذات التي نسعي لوجودها في الأشياء، فأولئك الذين يرون بالقمر روحًا ويعتقدون بالنجوم ذواتًا، وما كان من القدماء من اعتقادات في وعي الأشياء، يكشفون لنا عن نزعة البحث عن الذات المماثلة، وهذا من صنف البحث عن حياة في المريخ في هذا العصر، ومما سبق من الممكن أن نستشف أن المطرب في الأغنية يحقق لنا هذا الرجاء، فوجود صوت المطرب هو لذة إيجاد حياة على المريخ أو صحة الاعتقاد بذات فعالة للشمس والقمر.
إنني لست مع من يرى أن الموسيقى المجردة تؤدي ما لا يمكن أن تؤديه الأغنية( التي بالإضافة للموسيقى تتكون من الشعر والمطرب) لأن ما نريده في ذواتنا أكبر من النداء غير المكتمل وإن كان في حد ذاته جمالا لا ننكره.
التدهور الطربي مرة أخرى…
مع رتم الحياة السريع، واقتحام التقنية حياة الإنسان، بل والقفزة الكبيرة التي فعلتها الألعاب الإلكترونية في حياة الإنسان المعاصر وما تشكل من دور كبير للآليات، وتزاحم الأنشطة المشتتة، لم يعد للإنسان فرصة للإصغاء جيدا لما يشعر به جماليا، وقد تلاشى العمق الذي يدفع للتأمل والهدوء، ومن ثم فإن اللغة الشعرية بالنصوص لم تعد تلك الجاذبة. فعملية فهم الاستعارات مرتبط بالأساس بقوة العلاقة مع الطبيعة واللغة معًا، وبما أن التلذذ النفسي قد اتجه للشاشات وأما السماعي فهو مرتبط برتم الموسيقى السريع والمتوفر فإن الشعر ذاته أصبح بكثافة منخفضة في الغنائيات على أن الغناء منذ البداية ارتبط بالنصوص المتوسطة الجودة لسهولة غنائها، إلا أنه مال أكثر للمباشرة والاستناد على الصورة بالشاشة والفنون الراقصة، ولا يخفى أن كل هذا يدفع للسعي عن موسيقى مجردة مقابل غناء هش، وبالتالي فقد يكون ظهور الاهتمام بالموسيقى المجردة هو بالأساس انعكاس لتدهور الطرب ذاته.
عصام مطير