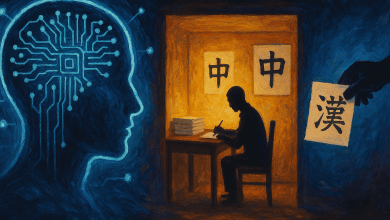الدائرة المهاجرة – لميعة عباس عمارة

الشعر مذكرة الشاعر ، إنه تاريخه الشخصي / الذاتي قبل أن يكون مادة أدبية وصفة ثقافية لمجتمع وعصر وحينما ننزع النص من حيوية صاحبه ونجعله في إطار التركيب والبنية ، سنفعل ما يفعله أهل التشريح بجثة هامدة ، سنعرف تفاصيل الأعضاء والأنسجة ، مواضعها وعلاقاتها، لكننا لن نعرف الروح أو الأصح الحياة ، فالحياة مزيج بين الإحساس (بالمادة) والعقل (بالانطباع ومقاومته) و الروح (بالحقيقة التي تظهر وتغيب ، وتخترق الصورة وتدافع عنها) والمرء ينال (الإحساس) الأكثر أولا و(العقل) الأقل ثانيا و(الروح) بندرةٍ أخيرا لأن الروحي له وعي خاص واشتراطات أعظم وأدنى مظاهره الشعر والفنون لكننا حتى حين نقول الروحي لا نتعالى عن الطبيعة بل نحسن إلى أنفسنا في استعمالها على غير ما هي عليه للتعبير عنا وإن ارتباطنا بها هو مصدر الشعر ، والإنسان تجربة في خضم العالم ، وهو بهذا قبل النص ، ومن يريد الشعر بلا واقعة يعيشها لن ينال سوى تكرار غيره ، ومن يود الرواية بلا فكر يجري في حياته فلن يكون سوى نسخة رديئة من كافكا أو دوستوفيسكي ولا يمكن للمكتبة أن تصنع موهبة ، إنما هي إضافات في العمل التأملي والتصارعي لنقدها أو القفز عليها بتوظيف المعرفة ومكتسبات اللغة، عبر (تجربتك )…
وأعود لأقول بالنسبة للنص لكي نمنحه حياته التي تستحق ، ولنرفعه لمستوى الوعي الذي هو فوق مستوى اللغة ، يجدر بنا الانتباه للحركة الذهنية التي يُحدثها فينا نحن القراء والمستمعين ، مع زيادة التصور بفاعلية الشاعر وحياته وموقفه من الحدث/التجربة التي يحكيها لنا ، وملاحظتنا لأساليبه التي تخصه والمشتركات بيننا .
إن من الأمثلة الرائعة على ذلك وفي إبراز شاعرية الشاعرة البديعة لميعة عباس عمارة أيضًا ، قصيدتها : الهجرة الدائرة
حيث يبدأ النص في سرديته ، من خلال ما يتيحه لنا الشعر الحر (شعر التفعيلة) الذي قدم إمكانيات جديدة للشعراء بجعل الوزن بين أيديهم ، أن تطيل وتنقص مدى الوزن/النظم/الغناء الذي تبني به نصك ومعانيك ، وهي مسؤولية وتحتاج مهارات اكبر من الوزن الثابت بالشعر العمودي الذي يسهّل عليك “اعتياد مداه ” من النظم ، فالشعر العربي قفز قفزة كبرى من خلال هذا التطور وقد قيل إن الشعر وعى ذاته بالعهد الرومنسي ، إذ كان شعرًا بالعصور التقليدية لكنه لم يكن واعيًا بها ، ويُقصد بذلك ارتقاء الشعر مستويات دلالية متقدمة بالتعبير عن الذات والحرية والخيال ، وهذه الفكرة السائدة بالغرب لها ما يؤيدها عند العرب (بعيدًا عن ذوق سلفية اللغة ) ، وها نحن نرى الآن كيف تقودنا لميعة على “البحر الخبب” لنصغي لقصتها ، ومشاعرها :
بين صخور الزعتر في ظاهر (صُور)..
سألتُ غريبًا : أين طريق قوافل (تبنين).. يكلفني عشق فتىً منها ، جهد السيرْ
أوشكتً أقولً
أرأيتَ السروة تلكَ ،
حببيي يلبس كل شموخ السرو
وأنا قاصدةٌ دار حبيي !
الحركة الذهنية بالنص كانت ظاهريًا قصصية وبسياق غير متشعب ، لكن شاعرية النص بعمقه في كون السؤال الذي سألته لغريب ، كانت قفلة الفقرة ، تعكسه ليكون الغريب ضمنيًا هو من سألها (إلى أين ذاهبة) (لماذا ذاهبة ) (لمن ذاهبة) لتجيبه :
“وأنا قاصدة دار حبيبي!” ، وبهذا فالغريب الذي سألته كان أيضًا هو من مثّل القارئ لتشرح لنا من خلاله عن سبب رحلتها ،
“أوشكت أقول” هي ذاتها “فقلت له” لكنها قالت لنا نحن ولم تخبره ، إنها براعة السرد هنا ، فالغريب الذي بالنص لا يعلم ونحن الغرباء خارج النص علمنا ، وقد نالت هذه الفقرة الشعرية من قصيدتها طريقة مدهشة في شعورنا بغرامها (للآن) ، فالحب هو من دفعها للسفر ، ومغامرة السؤال ، ثم عبر (أوشكت أقول) ، وهي قد قالته لنا لا للغريب كما أسلفت ، دفعتنا للشعور ضمنيًا بأن الغريب قد سألها (إلى أين ذاهبة هناك ولمن) في المشهد ، وفي هذا المضمار الذي يكون فيه ما هو ضمنيا مستشفا أو محتملا ، تبرز شاعرية المعنى الخفي ، ويتدفق الشعر وعيًا به من خلاله بالإضافة للوزن والألفاظ والجمل .
تلك الفقرة من نصها أيضًا ، اتخذت أسلوب المجهر الذي نحرك مفتاحه لتظهر صورة الشريحة واضحةً ، فالذي جاء بالنص بدايةً كان مقدمة لمشهد غير واضح وقد تحركت الشاعرة بالنص لإيضاح المشهد، بكونها هي محور النص وليس الغريب
بدءًا كان توقعنا بموقع كبير للغريب بالنص لكنه كان مجرد صدى ، وإبراز لها هي من خلال ما تشرحه لنا ، وبالتالي أصبح الغريب أيضًا نحن القراء (الغرباء) الذين يريدون معرفة (لمن ذاهبة).
ثم تكمل الشاعرة على لسان الغريب :
سيري وبساتين الليمون ،
سيهديك شذى القداح وزهر اللوز
فإذا صرت بساحة صورْ
سترين التاجر والزائر والعابر والجوال
يهدون خطاك إلى تبنينْ
إنْ ظلَّ بها من تبغينْ
،،
أجابها الغريب (سيري وبساتين الليمون ..) أصبحت بذلك الشاعرة هي الغريبة فها هو الغريب بالنسبة لها (ولنا أيضًا) يصبح ابن المكان وهو الذي يصف لها التفاصيل المكانية ، ويبدي رأيه بالناس ويثير سؤالا عن إمكانية بقاء من تسعى إليه ، وهذا القول يمهد للمشهد التالي ومسألة الهجرة والبقاء (إن ظل بها من تبغين).
شاطئ صُورْ
تمدّدَ عملاقًا أسطوريًا
أهمله التاريخُ ،
رمته الأمواج على الرمل جُفاءً
وأنا أمشي وحدي ضد التيار ..
أرقبُ زحفَ الغيم الأسودِ
تدفعه الريح الخرقاءْ
في الدرب الموحش بين الهجرة والإصرار..
نلاحظ كيف خرجت الشاعرة من المشهد لتدفع بشاطئ صور نحونا ، بإخبارنا عنه ، ومنحه الوجود الذي يستحقه ، ذلك الوجود الذي أهمله التاريخ ، وبذكرها إهمال التاريخ نشأ اهتمام الشعر الخاص بالمكان فها هي بشعرها تذكره ، وهذا الصراع بين التاريخ والشعر هو صراع قديم فالشعر أوفر فلسفة من التاريخ كما يقول أرسطو :
“كان الشعر أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ ، لأن الشعر أمْيَلُ إلى قول الكليّات ، على حين أن التاريخ أمْيَلُ إلى قول الجزئيات”
وهذا الكلي عند أرسطو هو العملاق الأسطوري ، ذلك الشعور بمعنى ضخم مرمى جفاء على الرمل ، فقد أشار الشعر هنا للمشهد الكلي أما الأحداث الجزئية فهي مهمة التاريخ في ذكرها ، وشاعرتنا قدمت لنا هذا الخلل بتاريخ أهمل كل هذا المعنى ، الذي أبصره الشعر وحده ، وليس فيما سبق فلسفة سعت إليها الشاعرة بمعناه الميتافيزيقي/الغيبي بل فيه النظرة التي يبصرها الشعر ولا يرقى لها التاريخ فهو معنيٌّ بالنهاية بالقوة لا العاطفة ، وبالحدث لا الروح ، وبالجماعات لا الإنسان ، وقد نستشف أيضا من قولها (أهمله التاريخ) أي لم ينتبه له جموع الناس بما فيه من جمال وحياة توحي بالأساطير التليدة وهذا رونق شعري , وبخصوص معنى أرسطو عن هذا الفارق بين الشعر والتاريخ أيضًا يجدر الحديث عن الحقيقة حيث يشرح الناقد الفرنسي جان ماريو غويو قول أرسطو في مقارنته الشعر بالتاريخ يقول فيه :
“لئن كان العالم يكتب تاريخ الكون مفصلا دقيقا ، فإن الشعر يكتب أسطورة هذا العالم إن صح التعبير ، والاسطورة وثيقة من وثائق التاريخ وكثيرا ما تكون أصدق من التاريخ أو كما يقول أرسطو : أكثر فلسفة من التاريخ” ،
وشاعرتنا بشاعريتها ونظرتها الكبرى للمكان ألقت لنا نقدها للتاريخ في التذكير بهذا الإهمال لتلك الحقيقة التي رأتها بهذا المعنى الشاعري .
ثم أعادتنا إليها (وأنا أمشي ضد التيار) وهي ترقب الرحيل ومقاومته (زحف الغيم الأسود ، تدفعه الريح الخرقاء ، في الدرب الموحش بين هجرة وإصرار).
وحدي أتحامل في أفق يشعله المغربُ والرعبُ
أيا ولدي الضائع في عتم الغيم وعطر الليمون
من لي بقميصك يهديني ؟
إني أتقطع حبًّا كي ألمس شعرك ، أو أبكي بين يديك .
وقولها “وحدي” هو قول شعري تام عند الشعراء ، فالقصيدة إبداع فردي ، والشاعر حين النظم ، هو وحده ، وبذلك فالشعراء خبراء بشعور الوحدة والتبرم منه أو التفاخر فيه شعريا ، (وحدي أتحامل في أفق يشعله المغرب والرعب ) ،نلاحظ هذه الإزاحة بالمفارقة ، يشعله-المغرب ، وقولها الرعب نفى السعة والجمال من معنى (الأفق) ، ثم نداء البعيد (أيا) (ولدي) .
إن التغير الكبير الذي وضعته الشاعرة بنصها هو الانزياح في قولها (ولدي) فبعد أن كان تصورنا عن معشوق غرامي فإذا بنا أمام أمومة طاغية باتجاه ولدها ، مما يدفع للتساؤل إن كان فعلا المقصود ولدها أم هو طغيان الحب ووصوله للأمومة لكننا سنندفع نحو تصور الأم وابنها ، ويا له من تحول بالنص .
الطير تهاجرْ
واللوز يهاجر ْ
والشمس تهاجرْ
إلا ولدي
حرفٌ أبيضُ في اللوح الأسود ، في مدرسة القرية
ونساءٌ بثيابٍ سودْ
يتماسكن بوجه الدباباتْ
وقولها (إلا ولدي) يفرض علينا شعور الأمومة الزاهي والمؤمن بالبقاء ، مقابل الهجرة ، وبهذا تضرب لنا الشاعرة تحولات بالنص تحكي لنا مشاعر الوطن ، الهجرة ، الأمومة ، الحب بقصصية شعرية جميلة ومدهشة حتى في توظيفها اللون وإقامة مشهد بين الأمل واليأس .
مثل هذه التكوينات الشاعرية بالنصوص ، موهبة في نضوجها كان للغربة والسفر والعذاب والتقلبات مع التركيب النفسي والثقافي لـ لميعة عباس دور في بروزه ، فهذا ليس نسقا شعريا للعصر بل هو تكوين خاص ممتد من أرواح نادرة ومختارة ، ولا تعاليم هنا سوى أن تعوا مدى المعجزة الشعرية وإمكانياتها ✨
عصام مطير
المراجع :
١. ديوان : أنا بدوي دمي ، قصيدة الهجرة الدائرة ، ص ٦٢-٦٣
٢.فن الشعر ، أرسطو طاليس ، ترجمة د. عبدالرحمن بدوي – دار الثقافة – بيروت ١٩٧٣م
٣.مسائلن الفن المعاصرة – جان ماريو جويو – ترجمة د سامي الدروبي – دار اليقظة دمشق ط٢ ١٩٦٥ ، ص١٢٨